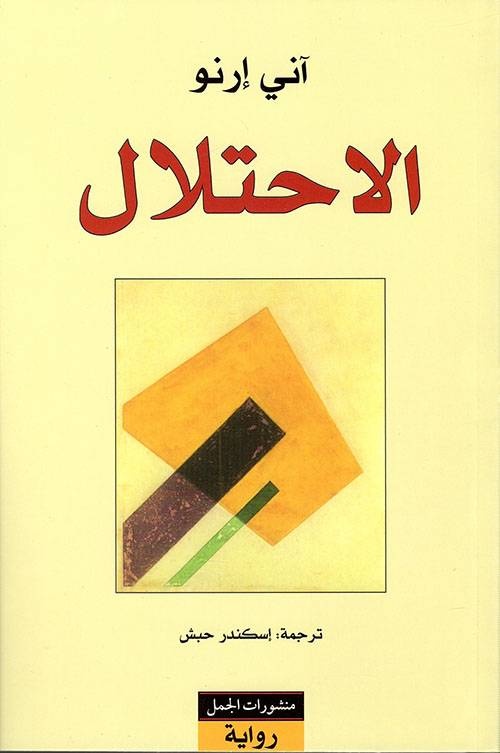هل تعيد «نوبل للآداب» وهج الفرانكوفونية المفقود؟
أعاد فوز آني إرنو الروائية الفرنسية التوهج إلى ثقافة الأمة الفرنسية، بالنظر إلى المكانة الثقيلة للجائزة الكونية العتيدة، فأن يظفر بها أديب فرنسي - أو فقط يكتب باللغة الفرنسية، يخدم اللسان والأدب والثقافة الفرنسية، ويعيد الثقة إلى الفرانكوفونية، التي أضحت تتداعى في أصقاع العالم، ولا سيما في القارة الإفريقية، نتيجة انحصار النفوذ الفرنسي في أكثر من دولة إفريقية، جراء الصراع، الناعم والخشن أحيانا، بين القوى الدولية الكبرى المتنافسة على القارة السمراء.
فطنت فرنسا مبكرا إلى أهمية صناعة نخب مثقفة "أنتلجنسيا"، تتولى حماية المصالح الفرنسية بمستعمراتها بعد منحها الاستقلال السياسي، من خلال الترويج للثقافة والأدب الفرنسيين، حتى تضمن الولاء والتبعية في هذه الدول. ذلك عن طريق الكتابة والتفكير والإبداع بها. فاهتمام وعناية صفوة المجتمع داخل هذه الدول باللغة الفرنسية، يرسخ في الوعي الجمعي لمواطني الدولة اقتران التقدم والفلاح، الفردي والجماعي، بمدى الإلمام والتمكن، وحتى التعلق، بلغة موليير.
تحولت الفرانكوفونية، من مجرد تسمية أطلقها أونسيم روكولو الجغرافي الفرنسي 1880، على الدول الناطقة بالفرنسية، إلى أقوى وأشد الأسلحة الناعمة التي تستعين بها فرنسا لتحقيق طموح الهيمنة، وفرض الاستعمار عن بعد. وكان بول هوفلان، الفقيه القانوني في جامعة ليون، صريحا في هذا الشأن، حين قال "إن تعليم الناس لغتنا، لا يعني ألفة أفواههم وآذانهم للصوت الفرنسي، بل يعني فتح نفوسهم على الأفكار الفرنسية، وعلى العواطف الفرنسية، وأن نجعل منهم فرنسيين من ناحية ما.. هذه السياسة تؤدي إلى فتح دولة بواسطة اللغة".
هكذا صارت الفرانكوفونية يد فرنسا الخفية التي بسطت مناحي الحياة في عدد من الدول، فالثقافة والتعليم يتنفسان من رئة فرنسا الثقافة، فالمدارس والكتب والإعلام والشوارع ولغة التخاطب والتعبير والفكاهة والنضال السياسي.. كل شيء بمفردات فرنسية، كما لو كنت تسير في جنبات شارع هوسمان أو باسي أشهر شوارع باريس. بذلك تحقق نبوءة منظر الفرانكوفونية، في كون اللغة عماد الإمبراطوريات، حيث كتب "إذا امتزجت لغة بشعب، فكل العناصر العرقية لذلك الشعب تغدو رهينة تلك اللغة".
يربط كثيرون بداية المشروع بـ1970، لحظة تأسيس المنظمة الدولية للفرانكوفونية، تحديدا 20 آذار (مارس) الذي تحول إلى يوم عالمي للفرانكوفونية. لكن الحقيقة غير ذلك، فبواكير انطلاقه كانت، مطلع القرن الـ20، مع تأسيس الجمعية العالمية للكتاب باللغة الفرنسية، ومثل خطاب الرئيس الفرنسي شارل ديجول 1944، بشأن بناء الاتحاد الفرنسي بعد الحرب العالمية الثانية، لربط مؤسسات المستعمرات بفرنسا الأم، محطة مهمة في هذا المسار. وفي أواسط القرن تشكل الاتحاد الدولي للصحافيين والصحافة باللغة الفرنسية، أعقبه 1966 بمقتضى مرسوم جمهوري، تشكيل اللجنة العليا للدفاع عن اللغة الفرنسية، أسندت إليها مهمة تطوير العلاقات الثقافية بين الدول الفرانكوفونية من المستعمرات.
ولادة الشكل المؤسساتي آخر مراحل مشروع الفرانكوفونية، فالتأسيس بمنزلة لحظة خروج الخطة الفرنسية من السرية إلى العلنية، بعد أزيد من سبعة عقود. وهذا ما جعل محمد حسنين هيكل المفكر المصري يكتب عن واقعة التأسيس، بكون "الفرانكوفونية تيارا غريبا طارئا، ظهر فجأة على ساحة المنطقة.. وهو مشروع منظمة غريبة لا تعبر بالنسبة إلى إفريقيا عن هوية ولا أمن ولا مصلحة ولا أمل، بل قامت على إنشائه الدولة الفرنسية بسلطتها، وتوجهه الدولة الفرنسية بأدواتها، وتديره الدولة الفرنسية بأجهزتها".
يصطف هيكل مع تيار عريض ينظر إلى الفرانكوفونية باعتبارها أداة هيمنة واستحواذ، كما جاء على لسان آلان موبانكو الكاتب الكونغولي/ الفرنسي "الفرنكوفونية وسيلة هيمنة، خصوصا حين نجد أن فرنسا ظلت تحتكر الحلول لمعظم مشكلات الشعوب الفرانكوفونية". يتعدى الأمر حدود تقديم ثقافة مغايرة، تبحث لها عن مساحة أكبر داخل ثقافة الآخر، نحو سياسة تعمل على تذويب الهويات المحلية، وإحلال هوية أجنبية مستوردة محلها، دون أدنى اعتبار للسياق والمحيط ولا أي شيء آخر.
يرى تيار آخر أن انغلاقية معارضيهم مبالغ فيها، فالفرانكوفونية نقطة قوة لا ضعف، ألم يعد كاتب ياسين الروائي الجزائري "الفرنسية غنيمة حرب". أليست قناة سهلت لغير الفرنسيين الانفتاح على الأدب الفرنسي ومن خلاله الأدب العالمي. أكثر من ذلك، أسهمت في نقل أصوات ومعاناة كثيرين، عربا وأفارقة، إلى رحاب العالمية، بعرضها على نطاق واسع. وكيف هؤلاء الكتابة بالفرنسية بمنزلة نقد مزدوج، ينطلق من لغة الآخر لتفكيك أساطيره، وكشف تناقضاته الذاتية.
فرض ثلة من الأدباء الفرانكوفونيين غير الفرنسيين، ينتمون إلى سياقات جغرافية وتاريخية أخرى، أنفسهم في سماء الأدب العالمي لعقود من الزمن، سواء في المنطقة المغاربية أو في أدغال إفريقيا أو حتى هناك في المشرق، بإنتاجات فكرية وأدبية، حجزوا بواسطتها موقعا في صف روائع الإبداع الإنساني العالمي. وإن كانت مطارحات الهوية المزدوجة رديفة كتاباتهم، فعادة ما تصطدم محاولات تقريظ هذه الإبداعات بثنائية الداخل الفرنسي والخارج الأصلي، وهذا ما أطلق عليه أحدهم "الإقامة عند العتبة"، فالكاتب حتما غير فرنسي، حتى لو شاء أن يكون كذلك.
لم يبق شيء من ذلك راهنا، فالأدب الفرنسي، بشهادة أصحاب الدار، في تقهقر عاما بعد آخر، بالتزامن مع تدحرج فرنسا على الصعيد العالمي، ما يذكرنا بمقولة باسكال بونيفاس الأكاديمي الفرنسي "لم يعد موضوع الفرنسية خيارا ثقافيا أو اقتصاديا، إنما أضحى رهانا استراتيجيا يكتسي أهمية حيوية لدى فرنسا". لذلك سارع الرئيس إيمانويل ماكرون، قبل أعوام، إلى إسناد مهمة "إعادة إرساء الفرانكوفونية" إلى الأديبة ليلى سليماني، التي أوضحت أنها ستعمل على "نفض الغبار عن الفرانكوفونية، وجعلها مواكبة للعصر"، مضيفة أن "طموحها هو إظهار أنها ليست مؤسسة منفرة ووريثة الاستعمار الفرنسي.. بل إن الأدب الفرنسي عالمي الطابع ورمز إثراء".
تنسى سليماني، المغربية الأصول والنشأة، أن دفاعها عن الفرانكوفونية يحمل في طياته دليل إدانتها، فالاستعمار الثقافي "الفرانكوفونية" أشد وطأة من الاستعمار العسكري. ألم يكن أونسيم روكولو الأب المؤسس صريحا، حين قال "الفرانكوفونيون الذين نقبلهم هم كل الذين أبدوا استعدادا للبقاء أو المشاركة في لغتنا، أولئك الذين نحن أسيادهم".
إقرار من أهل الدار بأن لغة مولير ليست بخير، ولا يتوقع لحالها أن تتحسن في المستقبل المنظور، رغم ظفر أحد كتابها بجائزة نوبل للآداب، وذلك راجع إلى امتزاج السياسة بالثقافة، فتتويج الكاتبة آني إرنو المحسوبة سياسيا على اليسار كان في زمن سيطرة اليمين واليمين المتطرف على الدولة في فرنسا، ما جعل الاحتفاء بها باهتا، باستثناء صحافية واحدة فقط "ليبراسيون" مقارنة بما حظي به الروائي باتريك موديانو 2014.