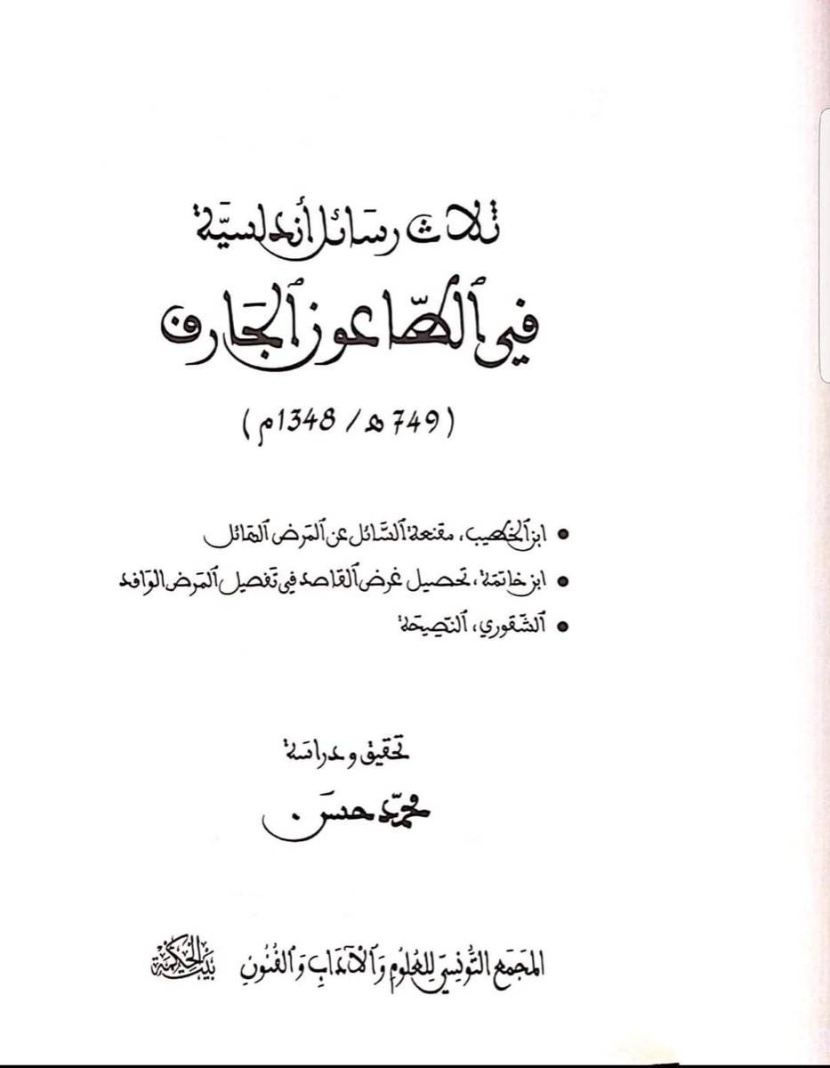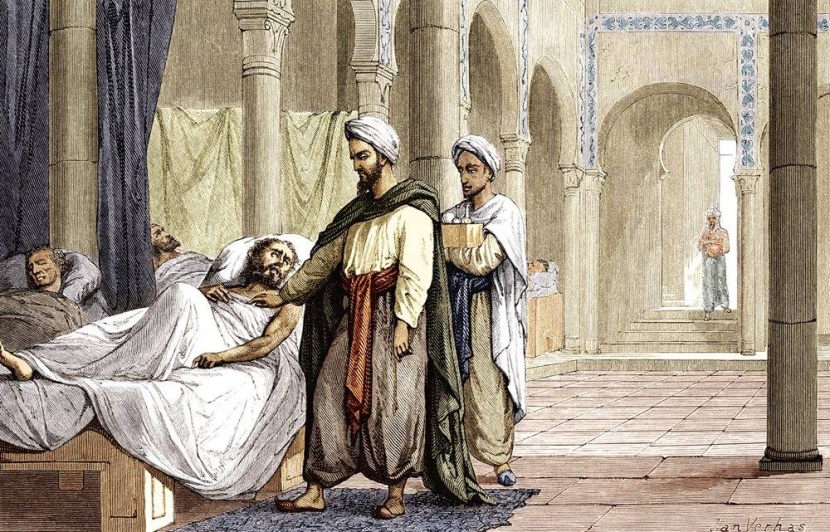ابن هيدور .. منارة عربية في علم الأوبئة
لم يتعرض المؤرخون العرب للأوبئة والمجاعات في كتبهم إلا لماما، فالأخباريون والرواة لا يوردون سوى النتف عن الجوائح التي تجتاح دولهم، وغالبا ما ترد هذه الإشارات كحواش على متن الأحداث الكبرى التي شهدها تاريخ الدولة أو الإمبراطورية. فقدماء المؤرخين لم ينظروا مطلقا إلى هذا النوع من الكوارث، باعتباره عاملا محوريا في قيام أو أفول سلطان الدولة أو الإمارة، بل أمرا عاديا يخضع غالبا للتفسير الديني الغيبي، أو يرد في أحسن الأحوال إلى فترات القحط والمجاعة والحروب.
ما جعل الكتابة عن الأوبئة شبه غائبة في المتن التاريخي عند العرب، فعادة ما يكون حضورها مقتضبا جدا، في سياق سردي عن الأوضاع العامة في الدولة؛ وما شهدته من بلاوى أتت على الحرث والنسل، أو حين الحديث عن سير أعلام قضوا بسبب هذا الوباء أو تلك الجائحة. ظلت الأوبئة في نظر هؤلاء مجرد وقائع بسيطة، لا ترقى إلى منزلة الحدث التاريخي الذي يستحق العناية والاهتمام.
لكن قلة من هؤلاء اختارت معاكسة هذا التوجه، فكتبت بإسهاب وتفصيل عما شهدته أو سمعت عنه من أزمات وكوارث، ومنهم من أفرد مصنفا للجائحة التي جايلها، كما هي حال الرسالة المفقودة لمحمد بن علي اللخمي الشقوري بعنوان "النبأ في أمر الوباء"، وفي السياق ذاته كتب أبو جعفر أحمد بن خاتمة رسالة "تحصيل غرض المقاصد في تفصيل المرض الوافد"، ونلاحظ هنا الكلمة المهمة "الوافد"، أي أن مصدر الوباء ليس محليا، إنما هو قادم من بلاد بعيدة. كما نجد مصنف الأندلسي لسان الدين عبدالله بن الخطيب، بعنوان "مقنعة السائل عن المرض الهائل"، متحدثا عن الطاعون الذي حل بأرض المغرب، قائلا "إن قيل ما عندكم في أصل هذا الوباء، ومذ كم ظهر في الأرض. قلنا هذا الواقع ابتدأ بأرض الخطأ والصين في حدود عام أربعة وثلاثين وستمائة. حدّث بذلك غير واحد من أولي الرحلة البعيدة والجولان كالشيخ القاضي الحاج أبي عبدالله بن بطوطة وغيره...".
وسط هذه القلة، يحتفظ التاريخ باسم مغربي، سجل قصب السبق في الكتابة عن الأوبئة من موقع الطبيب وليس المؤرخ، والحديث هنا عن أبي الحسن علي بن عبدالله بن هيدور التازي؛ المتوفى في مجاعة فاس "816هـ/1413م"، والمحسوب على مدرسة "ابن البناء العددي المراكشي" المعروف في علوم الحساب أو الرياضيات بلغة العصر، قبل أن يؤسس لنفسه مدرسة "أنملي" في مدينة تازة، التي تحدث عن إنشائها أستاذه ابن البناء نفسه.
عرف ابن هيدور في عصره إماما في علم الفرائض والحساب، وطبيبا ممارسا ومدرسا؛ فقد أنشأ قرب منزله بيمارستان "دار شفاء"، لمعالجة المرضى وتعليم الطلاب، وعلى أنقاض تلك الدار بني حديثا مستشفى مدينة تازة شرق المغرب، وسمي الحي الذي كان فيه باسم "درب الطبيب"، وله في تلك المنطقة ضريح معروف بين التازيين.
دفع استفحال الأوبئة في عهده، وتفشيها بين الناس، خصوصا الطاعون، إلى دراسة الظاهرة بحثا عن أدوية لها أو على الأقل وسائل تضمن الحماية منها، فألف في هذا الشأن رسالة بعنوان "المسألة الحكمية في الأمراض الوبائية"؛ توجد في صيغة مخطوط في الخزانة الحسنية في الرباط، تحت عدد 9605، عالج فيها مسألة تفشي الأوبئة في الأمصار، وجميع السبل للوقاية منها، وكأن رسالته تتحدث عن هذا العصر.
يتحدث ابن هيدور في مصنفه مازجا خبرة الطبيب بالمدرس الخبير، مؤصلا لما ستقعد له العلوم المعاصرة بعد عدة قرون، بالتأكيد على أن أصول الوباء تعود في شق منها إلى فساد الهواء الذي ينتج بدوره عن "الأبخرة المتعفنة الصاعدة من الأرض.. إذ ترتفع أبخرة فاسدة متعفنة من السباخ والبطائح المتغيرة.. والتربة الراكدة في الهواء وأقذار الناس وفضلاتهم والقتلى في الملاحم، وكل هذا يحدث عنه الوباء".
يعطي صاحب "التمحيص في شرح التلخيص" أسبابا أخرى لانتشار الأوبئة والجوائح في الأقطار، حيث ربطها بالجفاف وقلة الغذاء التي تدفع الناس إلى عدم الاحتياط، ما يسبب الوباء، فـ"فساد الأغذية المستعملة في زمن المجاعات وغلاء الأسعار يضطر الإنسان إلى تناول غذاء غير مألوف قد فسد وتعفن لطول زمانه فينفسد المزاج من هذه الأغذية، وتحدث الأمراض القاتلة".
يسعى هذا العالم إلى تأسيس قاعدة "علمية" بشأن الأوبئة، في تلك الحقبة الغابرة، حين يعد الجفاف أو الحرب يسببان الغلاء، والغلاء يؤدي إلى المجاعة، وهي بدورها تسبب الوباء. ويختم هذا البرهان بقوله "وهذا علم صحيح وقانون مطرد، لا يحتاج فيه إلى تعليل ولا إلى نظر في النجوم". يأتي حديثه عن النجوم في باب الرد والسخرية من أقاويل إخوته في حرفة الطب، ممن يربطون بين الأوبئة والأوضاع الفلكية.
يكتب ابن هيدور في باب "الوقاية من الأوبئة"؛ وكأنه يخاطبنا لمواجهة وباء كورونا، ملحا على الإنسان الراغب في الحماية بأن "يدبر الهواء الذي يتنفس به، إذ لا يمكنه تبديله ولا مندوحة عنه لسواه، إذ هو مادة حياته فيجب عليه إذ ذاك إصلاح جواهر الهواء من اتخاذ البيوت العالية ورشها بالرياحين.. وبماء الورد الممزوج بالخل، والتطيب به ومسح الوجه والأطراف والمواظبة".
ابن هيدور مثال آخر لقامة علمية كبيرة مغمورة في التاريخ، لم يسمع بها أحد في المغرب ولا في المشرق، ممن أبان إرثها العلمي علو كعبها في كل الحقول المعرفية التي اشتغل عليها. ولا أدل على ذلك من اهتمامه المبكر بدراسة ظاهرة الأوبئة، حين وقع على أدوارها، غير المباشرة، في إسقاط الأنظمة والإمبراطوريات.
طبعا لا يمكن أن نعد سقوط دولة أو قيام أخرى كان لسبب واحد فقط "وباء كان أو أي سبب آخر"، فالدول تسقط في العادة لمجموعة من الأسباب، تتكاثر وتتكاثف حتى تؤدي إلى السقوط. لكن لا يمكن أن ننكر أن سقوط الدولة الأموية مثلا كان من ضمن أسبابه كثرة الأوبئة، وأن من ضمن أسباب ترسخ الدولة العباسية أنها لم تعان من الأوبئة مثلما عانت سابقتها.