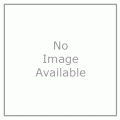نحن والأجنبي
بمناسبة الزيادة التي فرضتها جهات العمل الرسمية الفلبينية، التي تنص على رفع الأجر الشهري للعاملة المنزلية إلى 1500 ريال (زيادة بمقدار الضعف تقريبا) ـ التي لقيت معارضة شديدة وسخطاً من قبل المواطنين والمستقدمين السعوديين- رغم ذلك فإنني أضم صوتي للقلائل الذين سعدوا بهذا القرار وللأسباب الآتية:
ـ أولاً وقبل كل شيء فمسألة الأجور هي قضية دولية اقتصادية تخضع كغيرها من المتغيرات لقوانين العرض والطلب، إلا أن 200 دولار شهرياً هو راتب متدنٍ بجميع المقاييس بل لا يبتعد عن خط الفقر على المستوى الدولي ويدنو منه في الدول المتقدمة – بصرف النظر عن اقتصاد الدول المصدرة للعمالة.
ـ تزايد الخلل الهيكلي في سياستنا الأسرية فليس من المفترض أن توجد عاملة لكل بيت, ناهيك عن البيوت التي تستخدم جيوشا من الخدم. فمن واجب المرأة التي لا تعمل أن تشرف على بيتها ربما بمساعدة عاملة تأتي بنظام الساعة كما في الدول المتقدمة. وفي حالة المرأة العاملة فمن الأصح أن تعود إلى ممارسة وظيفتها بعد إجازة وضع ملائمة ومن الواجب أن توفر جهة العمل إما حضانة لأطفال الموظفات أو بدل حاضنة في ساعات العمل. إذن يصبح من المنطقي أن تزداد أجرة العاملة التي تغادر بلدها إلى مكان مجهول لا تعرفه على الخريطة وتقوم بخدمة منزلية 12 ساعة يومياً (على الأقل) على مدى عامين وبالعيش مع أسرة لا تعرفها "وهي وحظها" كما نقول بالعامية.
ـ المعاملة السيئة التي تلقاها العاملات المنزليات والحوادث اليومية تردنا في الصحف بشكل تقشعر له الأبدان إضافة إلى صعوبة (وليس استحالة) تحقيق العدالة للأجانب عند النزاع والخلاف مع المواطنين. عندما نشر خبر زيادة أجور العاملات الفلبينيات انهالت الردود على الصفحة الإلكترونية لتلك الجريدة المحلية بشكل يفضح فعلاً نفسيات هؤلاء المواطنين، فمنهم من تناول المسؤولة الفلبينية بالسب ومنهم من حقّر الفلبين وشعبها ومنهم من قال "فليذهبوا ويأت غيرهم فهم المحتاجون إلينا"! هل هذا صحيح؟ هل نحن لسنا في حاجة إليهم فعلاَ؟ حزنت حقاً عند قراءتي هذه الكلمات، وبما أن أصحابها قد أتقنوا التواصل بالإنترنت فكان من الأولى أن يتصفحوا موقع البنك الدولي ليعرفوا مستوى الأجور عالمياً وأجور هذه العمالة في الدول المتقدمة، فربما راجعوا أنفسهم قبل أن يظهروا غطرستهم على صفحات يقرأها العالم كله.
ـ أما في حالة المقيمين من غير العمالة عرباً كانوا أو عجماً، فإننا لم نفلح في الاستفادة من خبراتهم والاندماج معهم بشكل إيجابي وجذبهم إلى ثقافتنا وحياتنا بالترغيب والمحبة، ونسينا أن أغلب الدول العربية والأجنبية سبقتنا في العصر الحديث بمستوى تعليمي وانفتاح فكري متقدم. بل إن الغرور والاستعلاء طال المعلمين والموظفين وحتى المديرين وانتشرت لدينا ألفاظ ومعانٍ غير حضارية بعيدة عن التهذيب تستخدم في الخلاف والشجار، فنرى السعودي يتطرق مباشرة لدين الأجنبي أو فقره أو بلده وكأنها ألقاب بذيئة يحق له التنابز بها. أما إذا كان الأجنبي من دولة غنية أو قوية فيقال إنه أجنبي بلهجة "وما أدراه بعاداتنا؟" وكأن الأجنبي إنسان جاهل، وما إلى ذلك من المعتقدات التي تنم عن سوء سلوكي وجهل عميق بالعالم الخارجي.
ـ نتذمر عندما نعامل معاملة أقل من راقية عند زيارتنا لدول الأخرى للسياحة أو التعليم أو غيره، ونفسر ذلك بالمؤامرات ضد الدين الإسلامي والسعوديين وكأن العالم كله "فاضي" لنا! وبالمناسبة يسمى هذا في طب النفس الـ rationalization أو التبرير لأن المريض يفسر المكروه بإلقاء اللائمة على الآخرين لتبرير فشله الذاتي.
ما منشأ هذه السلوكيات السلبية؟
رغم العولمة وثورة الاتصالات والفضائيات، ورغم التوجيهات السامية من خادم الحرمين الشريفين بعدم التنابز بالألقاب والتناحر والعصبية القبلية، إلا أن الشعب السعودي لا يزال غير قادر على تطبيق هذه التوصيات ببساطة ولا الانفتاح على الشعوب الأخرى بمختلف طبقاتها، فما سبب ذلك؟
إحقاقاً للحق فإن الاندماج الفكري والاجتماعي بين مختلف الحضارات هو من التغيرات التي تحتاج إلى سنوات وربما قرون طويلة. وواقعياً فإن العنصرية والعرقية موجودة في أغلب دول العالم وعلى مر جميع العصور لكنها أمست من المنبوذات الاجتماعية في العصر الحديث ومن الممنوعات القانونية في بعض الدول بحيث يجرمها القانون المؤسسي والفردي في أغلب الدول الغربية وذلك بتوجيهات صارمة من واضعي السياسات المدنية. في رأيي ما يحدث هنا يعود جزئياً للأسباب الآتية:
ـ الازدهار الاقتصادي في فترتي السبعينيات والثمانينيات كان له أثر اجتماعي واضح تزايد في السنين اللاحقة، فقد تسببت الرفاهية المفاجئة نسبياً في الكثير من السلبيات السلوكية التي وقع ضحية لها جيل الشباب اليوم (إلا من رحم ربي). ومن هذه السلوكيات الاستنكاف عن القيام بالأعمال البسيطة والترفع عن قبول الوظائف المهنية وأحادية الفكر والتصنيف الطبقي للآخرين Stratification وعدم الالتزام وقلة الصبر. وهي تحديداً الصفات التي يشكو منها القطاع الخاص عند توظيف السعوديين.
ـ المناهج الدراسية– بما فيها المواد الدينية- لا تحوي أي معلومات مفيدة عن فكر الشعوب الأخرى أو حضاراتهم أو معتقداتهم، الأمر الذي أسهم في تأسيس العزلة النفسية والفكرية – ومن ثم الخوف والنفور- عن العالم الخارجي.
ـ عدم تدريس اللغات الأجنبية - وهي المدخل الرئيسي إلى الثقافات الأخرى - في مدارسنا الحكومية بشكل مبكر وفاعل. ففي لبنان مثلاً رأيت مستوى طلبة الابتدائية وهم يتحدثون بثلاث لغات –ومنها العربية - بطلاقة يعجب لها الكبار رغم أن ميزانية التعليم في لبنان ضئيلة مقارنة بميزانية التعليم في السعودية. بل إن الجدل مازال قائماً حول تدريس الإنجليزية في المرحلة الابتدائية (للبنين أم للجنسين!)، وفيما بعد تصرف المبالغ الطائلة على معاهد التدريب الفني "كمبيوتر ولغة إنجليزية"، التي في الأساس كان ينبغي تدريسها منذ مرحلة مبكرة.
ثم مرت السنون بسرعة وجاء عصر العولمة ووجدنا أنفسنا في مأزق: انضمامنا إلى منظمة التجارة العالمية قبل الاستعداد الفكري والاجتماعي لهذه العضوية. أصبحت المنافسة تقلقنا, خاصة في المنشآت التقليدية البعيدة عن الابتكار والحرفية، ومن ناحية أخرى باتت السعودة كابوساً ابتلي به القطاع الخاص. باختصار بدأت التحديات تظهر تباعاً وكل جهة تلقي باللائمة على الجهة الأخرى، فسوق العمل يضغط على القطاع الخاص والقطاع الخاص يلقي باللائمة على التدريب المهني والتدريب المهني يشكو من مستوى التعليم الثانوي والجامعي, وهكذا دخلنا في حلقة مفرغة بلا نهاية.
ورغم أنني في هذا المقال أتناول جزئية محددة وهي معاملة الأجانب في بلادنا، إلا أن المسألة ليست أحادية الجانب أو مقتصرة على سوء سلوك فقط، بل هي ناتج اجتماعي وثقافي له عدة مسببات وعوامل كما جاء سابقاً. أما المختصر المفيد فهو أن سلوكنا نحو الأجانب ونظرتنا الدونية للشعوب الأخرى يجب أن يتغير شئنا أم أبينا. ومهما طغى علينا الانغلاق والانعزالية فلو لم نحترم الآخر ونتعلم منه وننتهج التسامح والقبول سنجد أنفسنا مضطرين إلى فعل ذلك تحت ضغوط لا طاقة لنا بها فيما بعد. وحبذا لو يناقش مجلس الشورى وضع قانون ضد العنصرية والتفرقة على أساس العرق أو الدين أو الجنسية. فإن بعض الظواهر لا تتغير سوى بإيعاز صارم من المسؤولين وصانعي القرار.
ونهاية أنوه بأن مقالي هذا وإن اتخذ لهجة التعميم، فإنني أؤكد أن هناك أمثلة مشرفة لسعوديين نجحوا في إعطاء صورة مشرقة في حسن التعامل مع "الآخر" محلياً ودولياً من كبار المسؤولين وحتى أبسط فئات العمالة, بارك الله لهم.
همسة أخيرة
بطاقة حب لكل مقيمة تركت وراءها عائلتها وأولادها لكسب شريف في هذه البلاد.